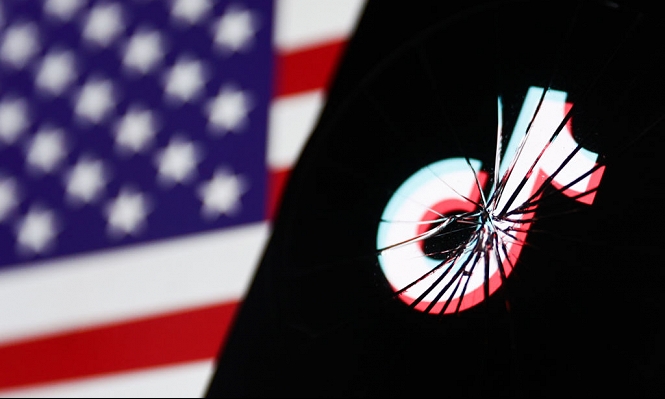سينما الأصوات الصامتة | حوار مع نجوى نجّار

* إذا أردنا أن نصنع فيلمًا، علينا أن نكون على قدر المسؤوليّة.
* لا أتجنّب بناء شخصيّة استشراقيّة، بل أفعل ذلك بتلقائيّة.
* لا أكتب قصّصًا من أجل الغرب، بل أكتبُها لأروي لنا قصصنا.
* الشخصيّة في «بين الجنّة والأرض» شخصيّة مجروحة وليس منهزمة.
وُلِدَت المخرجة الفلسطينيّة نجوى نجّار في العاصمة الأميركيّة واشنطن، وتلقّت تعليمها في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. حصلت على درجة البكالوريوس في «العلوم السياسيّة والاقتصاد»، ودرجة الماجستير في إنتاج الأفلام.
في عام 2000 أسّست في فلسطين شركة أفلام «أستورا»، ثمّ افتتحت فرعها الثاني في الأردنّ عام 2012. وكانت نجّار قد بدأت مسيرتها السينمائيّة من خلال الأفلام الوثائقيّة والروائيّة القصيرة، وشاركت في العديد من المهرجانات الدوليّة الهامّة ومنها «مهرجان برلين»، «كان»، «لوكارنو» و«هامبتونز».
ظهر فيلمها الروائيّ الطويل الأوّل عام 2009 باسم «المرّ والرمان»، وشارك في عدد من المهرجانات الدوليّة منها «صندانس»، «روتردام» و«القاهرة». وحصد فيلمها الثاني «عيون الحراميّة» (2014)، «جائزة أفضل إخراج» من «هرجان كالكوتا السينمائيّ»، و«جائزة الهرم الفضّيّ» لأفضل ممثّل من «هرجان القاهرة السينمائيّ الدوليّ». واستمرّ نجاح نجّار في فيلمها «بين الجنّة والأرض» (2019) والّذي حصد «جائزة نجيب محفوظ» لأفضل سيناريو، كما رشّح لـ «ائزة أفضل فيلم أجنبيّ» في «الغولدن غلوب» و«الأكاديميّة الأوروبيّة للأفلام».
في هذا الحوار الّذي تجريه فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة مع نجّار، نتحدّث معها عن فيلميها «بين الجنّة والأرض» و«عيون الحراميّة»، وعن الكتابة السينمائيّة، والقصّة الفلسطينيّة في السينما.
فُسْحَة: عادة ما تترك عبارة "مستوحى من قصّة حقيقيّة" مساحة للتفكير بالحقيقيّ وغير الحقيقيّ في الفيلم، وأريد سؤالك عن معنى العبارة الواردة في فيلم «عيون الحراميّة»، ولماذا من بين عديد الشخصيّات الغامضة الّتي ظهرت خلال «الانتفاضة الثانية»، اخترت قصّة ثائر كايد حامد، منفّذ عمليّة عيون الحراميّة؟
نجوى: لقد جئت إلى البلاد بعد «اتّفاقيّة أوسلو»، برفقة زوجي، وقبل ذلك لم أعش تحت احتلال ولا مررت بظروف كتلك الّتي عشتها في البلاد من حواجز عسكريّة، الجدار الفاصل، الاقتحامات، إلخ. كنت جئت من قبل زيارة برفقة والدتي قبل ذلك دفعتني للخروج بفكرة أوّل وثائقيّ اشتغلت عليه، ومن ثمّ جئت برفقة زوجي. كان لوضع البلد أثر كبير عليّ وعلى ماذا سأكتب، ولذلك بدأت في فيلم «المرّ والرمان» بقصّة زوجين يُسجَنُ الزوجُ وأتساءل في الفيلم عن كيف ستعيش الزوجة حياتها. كان قد مرّ على «أوسلو» فترة طويلة جدًّا عندما اشتغلت على «عيون الحراميّة»، وكان واضحًا كم هي «أوسلو» عبارة عن مزحة لا أكثر ولا أقلّ. كلّ ما مررنا بهِ خلال سنوات الانتفاضة جعلنا نشعر بأنّ ليس ثمّة أيّ تطوّر، ولا أيّ شيء يُظهِرُ لنا إمكانيّة الأمل، من الحواجز الّتي توقفُنا لعشر ساعات، والجدار الّذي أخذ يحرمُ الناس من أراضيها وحتّى من النور.
كان يفترضُ أنّنا في ظلّ «عمليّة سلام»، ومع ذلك لم نفهم كيف يُفترَضُ بنا أن نعيش، أو كيف يُفترَضُ بنا أن نربّي أولادنا، وماذا سنقول لهم. في ذلك الوقت كانت قصّة ثائر كايد، وكانت نابلس مغلقة منذ سنوات طويلة. بدأت أفكّر؛ إن كان هذا الشابّ أبًا، ولديه طفل أو طفلة، إلى أيّ درجة هو مستعدّ ليفعل ليحمي أولاده؟ كانت هذه هي العناصر الثلاثة؛ وضع البلد السياسيّ، عمليّة ثائر، ونحن كأهل، تلاقت مع بعضها ودفعتني لأفكّر بقصّة «عيون الحراميّة»، ولم يكن اختيارًا سهلًا. عليك أن تفكّر بشخص هو أبّ، وماذا يمكن أن يفعل إن حُشِرَ في الزاوية غير قادر حتّى على أن يتنفّس. كان الفيلم أيضًا بمثابة صرخة في وجه العالم، أنّكم لا تستطيعون أن تستمرّوا في خنق الناس؛ فهي صرخة من أجل الأمل في وضع كان الأمل معدومًأ فيه.
فُسْحَة: هل القصّة حقيقيّة؟
نجوى: كلّا، لعبت بالقصّة قليلًا، جعلتهُ مسيحيّ ولم يكن مسيحيًّا، ليس أنّ الأمر مهمًّا بالنسبة إليّ، ولكن لأنّني أفكّر بوطنيّة القضيّة، والغرب يعتقد أنّ القضيّة هي قضيّة المسلمين وأنّ المسيحيّين لا علاقة لهم بفلسطين. كلّا، هي قضيّة وطنيّة، وذلك ما أردت قوله. فجعلته مسيحيّ، وأب، وأخذت قليلًا من قصّته الشخصيّة مثل أنّه خاله كان قد استُشْهِدْ.
فُسْحَة: هل كان ثمّة بحث عن شخصيّة ثائر كايد قبل كتابة العمل، هل تمكّنت من الوصول إليه أو إلى أقربائه؟
نجوى: بالطبع أجرينا بحثًا، ولكنّ التواصل مع ثائر كان صعبًا جدًّا، ولم أتمكّن من الوصول إلى أقربائه. ولكن في فلسطين الجميع يعرف القصص، وكنت أعيش في البلاد عندما وقعت العمليّة. مع ذلك، حاولت إجراء البحث، ووجدت مقالًا واحدًا فقط عن ثائر في جريدة إسرائيليّة. لم يكن ثمّة أيّ إثارة سلبيّة حول الفيلم، وذلك يعود إلى أنّ القصّة مبنيّة على واقعنا نحن، إلى جانب أنّها مبنيّة على شخصيّة ثائر. في «المرّ والرمان» مثلًا، أخذت قصّة زوجة سجين، وقابلت الكثير من السجناء المحرّرين، وزوجات السجناء، لأنّ موضوع العلاقة ما بين السجن وزوجته ليس موضوعًا أعرف عنه الكثير، والفيلم لا يتحدّث عن السجين حصرًا، بل عن جسد زوجة السجين وكيف يتحوّل إلى سجن أيضًا. حاولت بقدر ما أستطيع أن أكون صادقة، ولكن بالطبع الفيلم ليس وثائقيًّا، بل يأخذ القصّة ويحاول أخذها إلى مكان آخر. أمّا القصص في «عيون الحراميّة» فقد كانت قصصًا عشناها بالفعل، لقد عشنا الاجتياح، الإغلاقات، تفتيش البيوت، انقطاع الكهرباء، والغضب الّذي يشعرُ به المرء عندما يجدُ الجدار محاذيًا لمنزله ويمنع عنه الضوء. هذه أشياء أستطيع أن أكون صادقة فيها بشكل عفويّ؛ فالفيلم ليس فيلمًا عن ثائر فقط، بل هو قصّة أب وأمّ، طفل، وسؤال عن الأبوّة والأمومة، وعن الطفولة والعلاقات المجتمعيّة أيضًا.
فُسْحَة: هل كان قرار الإبقاء على مشهد إطلاق طارق للرصاص على جنود الاحتلال قرارًا صعبًا؟ هل كان من الصعب قبوله في بعض المهرجانات العالميّة بسبب هذا المشهد؟
نجوى: بالتأكيد.
فُسْحَة: كنت مدركة لذلك، ومع ذلك أصررت على الإبقاء عليه؟
نجوى: كان ثمّة اشتراط بحذف هذا المشهد ليُقبل الفيلم في بعض المهرجانات، ولكنّ السؤال هو القصّة، ما هي القصّة الّتي نريد سردها؟ في النهاية ثمّة دائمًا تخويف وإسكات للرواية الفلسطينيّة، وكان ثمّة منع في السابق والآن ثمّة منع بطرق بديلة، ولم يكن ممكنًا أن نفكّر بأنفسنا أوّلًا؛ أن تفكّر بنفسك يعني الخضوع. إن كنت صادقًا وتصنع أفلامًا جيّدة، ستلقى نجاحًا كبيرًا، لا يهمّ هذا المهرجان أو ذاك، ثمّة طرق كثيرة لتظهر الأفلام. ما يهمّني هو عدم الخوف، فمن يخضع يخسر مصداقيّته، ويخسر حتّى صوته، والصوت هو ما تبقّى للرواية الفلسطينيّة. مِمّاذا سنخاف؟ ثمّة أناس قد خسروا أبناءهم، وأقلّ ما يكننا فعله، إذا أردنا أن نصنع فيلمًا، أن نكون على قدر المسؤوليّة. ولذلك، أجل، كلّما صنعنا فيلمًا نحن كأنّنا نلبس كفوف ملاكمة، ولكن لا أستطيع أن أقول لك أنّنا لم نحقّق نجاحًا، بل حقّقنا نجاحًا كبيرًا.
فُسْحَة: ولكنّك لم تُلاكِمي الغرب فقط، بل لاكَمتي شخصيّات فلسطينيّة أيضًا من خلال شخصيّة عادل؟
نجوى: نحن أيضًا لدينا مشاكلنا، فأنا لا أصنع سينما من أجل الغرب. إذا أردنا أن نكون جريئين سينمائيًّا، فذلك يعني التطرّق إلى مواضيع جديدة وطرحها، والجرأة لا تتعلّق بالغرب فقط، لأنّ الأهمّ بالنسبة لي هو الجمهور الفلسطينيّ والعربيّ، والتطرّق إلى ما لدينا من مشاكل أصلًا وكيف يمكننا التعامل معها. يهمّني عالمنا، لا الغرب، لا أكترث للغرب، سيكون لطيفًا لو كان ممكنًا التأثير وتغيير الصورة النمطيّة، ولكنّ ذلك ليس غايَتي النهائيّة. لذلك عندما أبني الشخصيّات أبني شخصيّات على علاقة بنا، تروي قصصنا نحن، وشخصيّة عادل موجودة في الواقع الفلسطينيّ، وتكرهه رغم أنّه صدّق فعلًا أنّه كان يساعدهم عن طريق خيانتهم، لذلك وجّه لهم السؤال: ماذا ستكونون لولاي أنا؟ ذلك كان خياره، وأعتقد أنّ وجوده يُغني الفيلم بطرق مختلفة.

فُسْحَة: قريبًا من نهاية الفيلم اعتقدت أنّ الفيلم سينتهي بعد لقطتين؛ الأولى عندما كان طارق على السطح يراقب مشهد زفّة عادل، والثاني عندما سُمِعَ صوتُ طلقٍ ناريّ، وقلت من الممكن أن تكون هذه هي النهاية. لكنّ الفيلم لم ينتهي، لا في المشهد الأوّل ولا الثاني. كان ثمّة واقعيّة غريبة، ما بين شعوري كمشاهد أنّك تقولين لنا على الرغم من إدراك الجميع لخيانته والكشف عن شخصيّته الحقيقيّة، لكنّ شخصيّة عادل لا تزال قويّة ولا يمكن هزيمتها في مشهد دراميّ، وفي الوقت نفسه، ثمّة طارق الّذي ترك عادل حيًّا بينما كان يمكنه أن يقتله، وكأنّك تقولين أنّ الخيار ليس فرديًّا، بل جماعيًّا؟
نجوى: كان مهمًّا أن يكون خيارًا جماعيًّا، ولم أكن أريده أن يقتل، ولكن أن يفعل فيه ما كان يُفعَلُ بالخونة عندما يُعدّون كذلك في إيرلندا؛ أن تُطلَق النار على ركبهم. ولم أُرِدْ أن تكون ملك قاتلة، هي ليست قاتلة، وهذه ليست طريقتنا، على العكس، أردتُ أن يظهر شخص ما قد يكون والدها ويتكلّم معها كأب، لأنّنا جميعًا لدينا مسؤوليّات، ويُسلّمها لوالدتها وهو يعرف أنّ قلبها سينكسر. بالنسبة لي، الفيلم ينتهي عندما يُهدِي طارق الورد الّذي كان قد جلبه لزوجته لحبيبته؛ أي رمزيّة استمرار الحياة، استمرار الوطن والحبّ، هذه هي الأشياء الّتي أن أترك المشاهد معها.
فُسْحَة: في رسالته الأخيرة لملك، لم يكتب طارق تأمّلاته أو أفكاره فحسب، بل كان يسلّمها قدرتها على أن تكون فاعلة في المستقبل، وهذا يُحيلُني إلى سؤالي التالي عن الأنثويّة السلبيّة في الفيلم، والذكوريّة الطاغيّة؛ فعلى العكس من فيلم «بين الجنّة والأرض» حيثُ الشخصيّة النسويّة متمكّنة وفاعلة متمثّلة في شخصيّة المرأة الدرزيّة وسلمى على سبيل المثال، تظهر الشخصيّة النسويّة في «عيون الحراميّة» سلبيّة ومحاطة بالنسيج، الألوان والقماش، ما السبب وراء ذلك؟
نجوى: النساء هنّ من ينسُجْن، أنت ترتدي الملابس ولكن من يُمسكُ بكلّ شيء؟ لا أعدّ الشخصيّة النسويّة سلبيّة في الفيلم؛ فالأمّ هادئة، صامتة، وهي لديها بنت ليست ابنتها، ونعرفُ وضعيّة المرأة غير المتزوّجة ولديها ابنٌ ومتبنّية لابنة أخرى. حاولت أن أكون واقعيّة في تصوّرها؛ كم بإمكانها أن تكون قويّة؟ هي امرأة تعيشُ يومًا بيوم، تحاول فقط أن تُمضِي الوقت وتُبقِي على أولادها برفقتها وتحاول فعل كلّ شيء حتّى لا تتزوّج عادل، تشتغل ليلًا نهارًا، وتحاول في أشياء أخرى ليكون لديها خيار ألّا تتزوّجه. في النهاية تمكّنت من ألّا تتزوّجه، والمجتمع الّذي كان يحدّ من قدراتها في السابق أصبحَ يدعمها ويقدّر ما فعلته بتبنّيها لابنة طارق، ابنة البطل الّذي وقف في وجه عادل. هذه الفتاة معها الآن، وذلك كان دورها، وهو ليس دورًا سلبيًّا في رأيي، ربّما يكون دورًا مختلفًا ولكنّه حاضر في مجتمعنا وليس سلبيًّا.
فُسْحَة: ثمّة أفلام تُنفِّرُ من امتلائها بالكليشيهات، وثمّة أفلام تُخيِّبُ أمل المشاهد، بشكل إيجابيّ، لخلوّها من الكليشيهات، وأعتقد أنّ «عيون الحراميّة» يقع في التصنيف الثاني. مثلًا، في ما يتعلّق بشخصيّة عادل، لو كانت تقف وراء الكاميرا مخرجة أو مخرج آخر، لربّما ظهرت عديد المشاهد الجنسيّة الافتراسيّة في المساحة الضيّقة بين مكتب عادل وغرفة الخياطة المليئة بالنساء، ولكنّ ثمّة ذكاء في بناء الشخصيّات يُجنِّبُها أن تكون شخصيّات مبنيّة بشكل استشراقيّ. وبذلك يكون السؤال كيف تجنّبت بناء شخصيّة استشراقيّة؟
نجوى: لقد درست «سياسة واقتصاد» في الولايات المتّحدة، وكذلك الماجستير في السينما، وقرّرت دراسة الماجستير في السينما لكثرة ما رأيت أعمالًا استشراقيّة تعبث بالتاريخ، بصورتنا وبكلّ شيء. لم أجد نفسي في الكتب الّتي درستها ولا في السينما الّتي شاهدتها، وكنت أمام خيارين؛ إمّا الاستمرار في التذمّر أو أن أصنع شيئًا مختلفًا. ولذلك لديّ وعي كبير بمسألة الاستشراق وكيف يرانا الغرب، وفي الوقت نفسها فالكثير من القصص الّتي أتناولها مبنيّة على أناس من حولي، وكما قلتُ لك من قبل، لا أروي قصصي من أجل الغرب، وصدّقني، لو كتبت شخصيّات استشراقيّة ولو قليلًا لكان عندي نجاح أكبر بكثير، ولكنّي لا أريد فعل ذلك. شخصيًّا لا أفكّر بالأمر، هي عمليّة تفكير تلقائيّة، وذلك يعود إلى ما قرأته وإلى طبيعتي الشخصيّة وتجربتي كذلك مع العنصريّة عندما كنت فتاة صغيرة في مدارس أجنبيّة وكنت السمراء صاحبة الاسم العربيّ الّذي لا يستطيع أحد أن ينطقه. كلّ هذه الأشياء جعلت التلقائيّة في صناعة الشخصيّة في دمي، حتّى أنّني لا أفكّر بما أكتب، فقط أكتب ما أشعرُ به، وما أعرفه، وأكتب الناس من حولي بالطريقة الّتي أراهم فيها بوصفي منهُم.
لكن ثمّة جانب آخر ألاحظه بدرجة متزايدة في الكتابة، والكتابة هي أهمّ شيء، وهو إدراك أنّ هذه القضيّة تستحقّ وقتًا طويلًا في العمل على السيناريو، تستحقّ أن تقوم بالبحث، أن تستمع للناس من حولك، وأن تعيش الوضع كما هو، وتذهب إلى الأماكن، وتشتمّ رائحة الطبيعة وتراها. عندما أسمع أحدهم يقول أنّه كتب السيناريو في ثلاثة أيّام أنظر إليه وأتساءل: حقًّا؟ لماذا؟ فلسطين تستحقّ أكثر من ثلاثة أيّام حتّى يكون الفيلم عنّا ولكي تشبهنا الشخصيّات وتتكلّم لغتنا.
فُسْحَة: عندما نتكلّم عن الصدق في الكتابة، ما الّذي يعنيه الصدق؟
نجوى: ألّا أكذب على نفسي، لأنّه من السهل أن يكذب المرء على نفسه عندما يكتب، فيكتب شيئًا يعجبُ فُلان، وإن عدّل شيئًا ما سينجح هناك، وإن زاد شيئًا سيعجُبُ آخرًا. وهذه العمليّة تفقِدُ القصّة مصداقيّتها، تصبحُ مرهونة لعوامل خارجيّة، والعوامل الخارجيّة هي أن تذهب إلى مهرجان هنا أو هناك. بالنسبة لي بوصفي كاتبة، أفضّل أن أظلّ مخلصة للقصّة ولنفسي، أي ألّا أكذب على نفسي، وذلك مرهق، وأنا الآن مرهقة لأنّني أشتغل في كتابة سيناريو منذ عشرة شهور، والآن فقط انتهيت من الكتابة على كتابة أخرى وأخرى. هذه هي المصداقيّة، ليس أن يكون طارق نسخة عن فُلان، الفيلم ليس وثائقيًّا، بل أن تكون القصّة نفسها صادقة.
فُسْحَة: أريد البدء بالثيمة الأكبر في «بين الجنّة والأرض» وهي التنوّع العرقيّ ما بين الفلسطينيين، اليهود العرب والدروز، وغيرهم. لماذا كلّ هذه الشخصيّات؟
نجوى: لأنّها موجودة، هذه القصّة بدأت عندما كنت في حيفا برفقة زوجي، وبطريقة ما عرفنا عن قرية إقرث المهجّرة، وبدأنا رحلة بحث عن القرية، عشر ساعات من البحث المتواصل، وصلنا إلى الحدود اللبنانية، ضعنا في مستوطنات إسرائيليّة، طرقات كثيرة ولم نجدها، ومن ثمّ تكلّمنا مع صديقة وحاولنا مرّة أخرى أن نجد القرية حتّى في النهاية وجدنا كنيسة، وبقربها شارع ضيّق جدًّا، ووجدنا مقبرة قرب الكنيسة. هناك خرج لنا شباب في العشرين من عمرهم، لا يزالون يدافعون عن قريتهم المهجّرة أصلًا، وهناك فكّرتُ أنّ هؤلاء الشباب مثلهم مثل الشباب في الضفّة الغربيّة والقدس، والفلسطينيّين في الخارج ممّن يحاولون الحفاظ على ارتباط مع بلادهم. كان ذلك مذهلًا، وكان صادمًأ أنّني الّتي أقرأ وأرى الكثير لم أكن أعرف شيئًا عن إقرث. شرعنا في بحث بالسيّارة عن القرى الدرزيّة، المسلمة والمسيحيّة، أخذنا نتكلّم مع الناس، وفي كلّ مرّة نعود فيها نعود بقلبٍ ممتلئ. وكان السؤال كيف سأروي قصّة تحتوي على كلّ هذه العناصر الّتي منها تشريد أهل فلسطين، ومنها فلسطينيّو الداخل ممّن يعانون المعاناة ذاتها الّتي يعانيها فلسطينيّو الضفّة الغربيّة، ولكن دون أن يُسلّط الضوء على قصصهم بالدرة نفسها، وليس أنّ ثمّة معاناة أكبر من أخرى، المعاناة واحدة في كلّ مكان.
هكذا بدأت بالشخصيّات وبنائها؛ من يكون تامر؟ من تكون سلمى؟ من هم عائلتها؟ وفي تلك الفترة كان لدينا أصدقاء كثر في الناصرة، وبدأنا نسمع قصصًا عن الحزب الشيوعيّ وإغلاق المكاتب وأشياء أخرى لم أكن أعرف بها وكثيرون لا يعرفون شيئًا عنها. ونحن لا نعرف لأنّ انقطاعًا حصل، كان ثمّة طلاقًا بيننا وبين بعضنا، ففكّرت أنّ أفضل ما أستطيع فعله هو كتابة قصّة عن علاقة حبّ بين اثنين يريدان الطلاق، وخلال القصّة سنمرّ بكلّ مواقع الحبّ هذه. وخلال هذه القصّة ظهرت قصّة سرقة أجهزة الدولة في إسرائيل لأطفال اليهود العرب، وبحسب الإحصائيّات الّتي تظهر الآن، فثمّة ما يقارب الثمانية آلاف طفل يهوديّ عربيّ سرقتهم الدولة. وهذا ما يجعلك تدرك عدم أهمّيّة من تكون بالنسبة للدولة في إسرائيل؛ قد تكون يهوديًّا، مسلمًا، مسيحيًّا، درزيًّا، ولكن طالما أنت عربيّ فستُمارس العنصريّة ضدّك. وكان مهمًّا بالنسبة إليّ أن تُعالج هذه المسألة في الفيلم، لأنّ ثمّة عدد كبير من اليهود العرب في إسرائيل ممّن يتكلّم أجدادهم وآباءهم العربيّة في حين أنّ الجيل الأصغر يرفضُ هويّته العربيّة ويكرهون أنفسهم بسبب سياسات الدولة.
هذه العناصر كلّها حاضرة في الفيلم، كانت أشياءً واجهناها، ورأيناها وحاولنا من خلالها بناء القصّة، ولكن مرّة أخرى، لم أرغب في صنع وثائقيّ، ففي حالة المرأة الدرزيّة أردتُ قصّة لها، أردتها أن تحمل البندقيّة وتحلم بالشام. أي أنّني أخذت الواقع وحوّلته إلى شيء آخر، فمرّة أخرى، هذه مهمّتنا في السينما؛ أن نحوّل الواقع إلى خيال.
فُسْحَة: إذن فرمزيّة الطلاق في الفيلم تعود إلى طلاق المجتمع الفلسطينيّ مع نفسه، أو انقسامه على ذاته، ورفض المجتمع لصلات كانت أصلًا موجودة في الماضي. في ما يتعلّق بمسألة النضال اليهوديّ العربيّ الفلسطينيّ المشترك؛ فهذه مسألة شائكة، ثقافيًّا، اجتماعيًّا وحتّى أكاديميًّا، وقراءتها في هذه المرحلة قراءة سلبيّة وينظر إليها على أنّها خيبة أخرى من خيبات تصديق بعض الفلسطينيّين لإمكانيّة نضال مشترك مع الإسرائيليّين لتحقيق السلام، أو العدالة، أو المساواة في ظلّ البنية الاستعماريّة القائمة.
نجوى: صحيح، وهذه هي المسألة، ولذلك فضّلت سلمى الانتقال والعيش في الضفّة الغربيّة المليئة بالحواجز العسكريّة والجنود على أن تظلّ بقرب خيبة والدها السياسيّة.
فُسْحَة: فضّلت الصراع الواضح على ميوعته في الداخل المحتلّ، خاصّة في ما يتعلّق بالتحالفات الفلسطينيّة الإسرائيليّة؟
نجوى: صحيح.
فُسْحَة: وذلك ينطبق على كافّة الشخصيّات في الفيلم؛ فالشخصيّة الذكوريّة الّتي تحدّثت عنها من قبل، والمتمثّلة في تامر، والد سلمى، وحتّى الشخصيّة الصوفيّة الّتي أقرأها بوصفها شخصيّة غير سياسيّة تبحثُ في الداخل هربًا من الخارج ومن مواجهة الواقع، وبرأيي ذلك ما جذب سلمى إلى هذه الشخصيّة، فهي الأخرى تشعر بالعجز في الواقع، وتفضّل الاستسلام والهرب إلى الداخل. إذن فالشخصيّة الذكوريّة في «بين الجنّة والأرض» هي الشخصيّة السلبيّة غير الفاعلة، لماذا؟
نجوى: أنت تقول سلبيّة، وأنا أقول أنّها شخصيّة مجروحة؛ ليس ثمّة شخصيّة في الفيلم أستطيع وصفها بالسلبيّة، لأنّي حاولت بناء شخصيّة لديها الجيّد والسيّء، شخصيّات تشبه إخوتنا، آباءنا، وأناس نعرفهم ممّن لديهم الحسنة والسيّئة. مثلًا، لديك الأب الّذي يقول لزوجته:"خلص، حلّي عنهم، مش ضروري هلأ يعملو اشيا"، والّذي على تفاهم كبير مع ابنته، ولكن لديه وجعه السياسيّ. أمّا الأمّ فهي حشريّة، وتتدخّل في كلّ شيء، ولكن في الوقت نفسه تغطّي على زوجها وتحاول بقدر ما تستطيع. ولديك تامر، ولديه جرح عميق جدًّا وصعوبة في التعبير عن مشاعره، ولكن عندما اقترب ذلك الشابّ من زوجته هجم عليه يضربه. هو يحبّ سلمى ولا يريد الانفصال، ولكنّه غير قادر على التعبير. وهناك سلمى، القويّة، ولكن أيضًا غير قادرة على فهم المدى الّذي يصل إليه جرح تامر، وإلى أيّ درجة هي الأخرى تهرب من الواقع. لكنّ تامر عاش واقعًا مريرًا لا يمكن تخيّله، لا يمكن تخيّل مشاهدة والديك يُقتلان أمامك ومن ثمّ تذهب لتقابل عشيقة والدك. هذه الأشياء الّتي أحاول قياسها بالمقارنة بنا كي يكون ممكنًا التعلّق بالشخصيّات، بكلّ سلبيّاتهم.
فُسْحَة: أعني بالسلبيّة نوعًا من العدميّة الجوّانيّة الّتي تجعل الفلسطينيّ سواءً كان تامر، أو والد سلمى، أو حتّى اليهوديّ العربيّ، تجعلهُ يشعر بأنّه عالق في آلة صهيونيّة لا تتوقّف عن تحويل الواقع إلى جحيم، ما يولّد طاقة عدميّة تنبع من عدم قدرتنا على فعل أيّ شيء، وحتّى نضالاتنا الصغيرة تنتهي إلى طرق مسدودة، ولذلك كان جميلًا الموازاة ما بين هذه الصراعات الكبرى وما بين علاقة تامر وسلمى الممكن إصلاحها.
نجوى: ثمّة الكثير من أصدقائنا الّذين هم أبناء شهداء، ووجدتُ في علاقتي معهم أنّ ثمّة طريقتان للتعامل مع أن تكون في هذه الحالة؛ أوّلًا، ثمّة من لا يريد أن يعرف شيئًا، ولا يريد أن يسمع شيئًا، ولا يريد أن يتكلّم عن والده ويريد أن يبعد نفسه بقدر المستطاع عن السياسة. أمّا النوع الثاني، وأكثرهنّ نساء، يمتلكن فخرًا كبيرًا، ويُرِدْنَ أن يكنّ مثل آبائهنّ، ويعِشْنَ في ظلّه ولكن لا يستطعن الوصول إلى المستوى نفسه. فعندما بنيت شخصيّة تامر، بنيتُها على هذا الأساس، يمكن أن يكون تحليلك صحيحًا، ولكن عندما كان هناك مواجهة بين تامر وتمير، شخصيًّا أردتُ من تامر أن يضربه، وأن تكون المواجهة أعنف، ولكنّ ذلك لم يحدث لأسباب مختلفة، ولكنّ ذلك ما أردته.

فُسْحَة: مرّة أخرى، الشخصيّة الذكوريّة في الفيلم محيّرة قليلًا؛ فمثلًا، شخصيّة تامر الّتي تحدّثت عن أنّها تعيش في ظلّ والدها، والّتي تدفعها سلمى للبحث والتنقيب عن ماضيها، ويشعرُ هو نفسه بشكّ في استحقاقه لحبّها ولديه مشكلة التعبير عن هذا الحبّ. لماذا تصرّ شخصيّة مركّبة بهذه الطريقة، بإمكانها أن لا تكون ذكوريّة، على ذكوريّتها؟
نجوى: لا أراها ذكوريّة بقدر ما هي طفولة. تامر يبحث عن إثبات ذاته بكلّ طريقة ممكنة، أولئك الّذين كَبِروا دون والدين سيواجهون مشاكلًا في النضج، وهكذا شعرت مع تامر، هو نوعًا ما أشبه بالطفل، الطفل غير القادر على التعبير عن مشاعره بوضوح. أنا الّذي سأسوق، هي تركت البيت، وطلبت الطلاق، ومع ذلك يصرّ هو على أن يسوق السيّارة قبل أن يصلوا إلى الحاجز الإسرائيليّ. هي ليست ذكوريّة بقدر ما هي إثبات وجود، إثبات ذات، وهو يعيش في مكان غير قادر على التحرّك فيه، وهي تريد منعه من السواقة في المكان الوحيد الّذي يستطيع فيه أن يسوق السيّارة. هو خليط بين ذكوريّة وطفولة، إثبات ذات وتردّد. وأيضًا ثمّة سؤال عليّ أن أجيب عنه بطريقة غير الكلام المباشر، وهو لماذا تريد تطليقه؟ عليّ أن أوضح الأسباب دون التكلّم عنها مباشرة، مثل كم هو عنيد، وكم هو غير قادر على التعبير عن مشاعره. التفاصيل الصغيرة هي الّتي تهدم الزواج، وهي التفاصيل الّتي أردت إيضاحها من خلال كلّ هذه السلوكيّات.
فُسْحَة: أفكّر الآن بفكرة الهرب الّتي تكلّمنا عنها في البداية وكيف يمكن ربطها بجيل من الذكور الفلسطينيّين المهزومين الّذين لم يتبقّى لهم غير بضع عادات سلبيّة يتمسّكون بها ليُثبِتوا أنفسهم كذكور، واستحقاقهم أو حتّى ذاتهم، فهل يمكن انطباق هذا على حالة تامر؟
نجوى: ليثبت نفسه كإنسان، وليس كذكر، هو فقط يحاول أن يمتلك صوته الخاصّ، بمعنى أنت تريدين الطلاق، فليكن، ولكن أنا من سيقود السيّارة.
فُسْحَة: صحيح، كإنسان، ولكنّ هذا الإنسان سيعبّر عن نفسه بالطريقة المبنيّ فيها اجتماعيًّا من قبل، وذلك البناء بناء ذكوريّ، وسيعبّر عن نفسه بالأدوات المتاحة، أو المبنيّة مشروعة للذكور. وهذا يمكن أن ينطبق على والد سلمى أيضًا وسلوكه الكحوليّ الّذي يعبّر عن حزن عميق ورثاء لمرحلة كاملة ولذاته أيضًا، بالمقارنة مع الذكر اليهوديّ العربيّ المستعمِر الّذي يبدو بحالة جيّدة بالنسبة لإنسان هُزِمَ سياسيًّا أيضًا.
نجوى: لأنّه أخذ كلّ شيء، لا نستطيع أن نغفل عن ذلك، لقد مات جدّي مقهورًا على ما ضاع من البلاد، ولا يمكن الاستهانة بذلك. أنا أردتُ أن أظهِرُ الضعف ولكن ليس الهزيمة، لذلك كان والدها يشرب أجل، ولكنّه كان لا يزال الإنسان نفسه الّذي يفهم ابنته، يستوعبها، يحتضنها ويحبّها. هو ليس منهزمًا، هكذا أرى الأمر. أرى أنّه من الممكن أن تلجأ لشيء مثل الكحول كي تنسى، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كحوليًّا عنيفًا. مسألة الأبوّة معقّدة، وأنا لا أحبّ الأسود والأبيض، ولكن التعقيد، الخليط، مثل عائلاتنا.
فُسْحَة: في مشهد النهاية يُنادِي كاتب العدل على الرقم 48، ولكنّ تامر وسلمى لا يتحرّكان من مكانهما، كأنّهما يرفضان الطلاق، هل ثمّة رمزيّة هنا؟
نجوى: البعض يقول أنّهم يم يتطلّقوا، والبعض يقول تطلّقوا، وثمّة من يفكّر فيه بوصفه نداءً لأهلنا في الأراضي المحتلّة عام 1948. أحبّ أن أسمع ما يفكّر به الناس. هي رحلة كانوا فيها سويًّا، وأنا أفضّل دائمًا الأمل في النهايات، وهذا أقلّ ما تستطيع السينما الفلسطينيّة أن تقدّمه. أشعر بالضيق عند مشاهدتي لفيلم بلا أيّ إيحاء بالأمل، ربّما يكون الواقع صعبًا مريرًا ويبدو أسودًا، ولكنّنا لا نستطيع فعل أيّ شيء دون أمل، ولذلك أحبّ أن تكون النهايات مفتوحة.

كاتب وباحث ومترجم. حاصل على البكالوريوس في «العلوم السياسيّة»، والماجستير في «برنامج الدراسات الإسرائيليّة» من «جامعة بير زيت». ينشر مقالاته في عدّة منابر محلّيّة وعربيّة، في الأدب والسينما والسياسة.